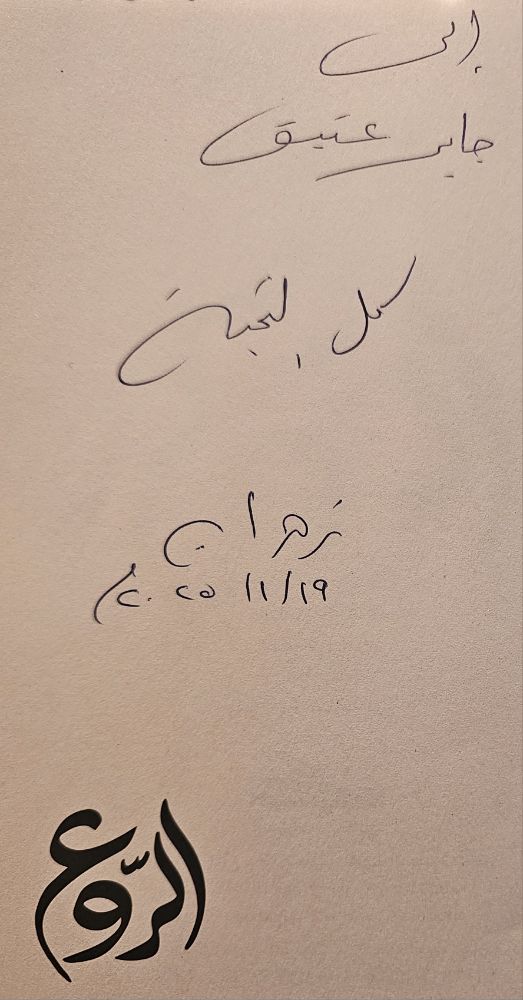

الروع كما يسميه أهلنا في عمان هو الفزاعة التي يستخدمها المزارعون في أنحاء العالم لإخافة الطيور والحيوانات السائبة وحماية المحاصيل منها، ولم تكن الفكرة على هذا النحو في البداية من الأساس، لكن لكل خبرة بشرية تسلسلها، حتى تنموا وتصل لحدها النهائي، وتترسخ في نفوس أصحابها، وهذا بالضبط ما يكتب عنه الرائع زهران القاسمي؛ لأنه يتحدث عن فكرة ترسخت في نفوس المزارعين، يشرح طقوسها وآلية عملها وأساطيرها في مساحة سماها رواية، ومن حقه أن يطلق عليها هذه الصفة؛ لأن الروع أو الفزاعة هو البطل الحقيقي، هو الأسطورة ومن تدور حوله الفكرة والأسطورة، ورغم وجود شخصيات كثيرة في الرواية، إلا أنني كنت أبحث عن تطور الروع وكأنني أرتقب بعث الروح فيه ليعيش الحياة التي أرادها “محجان” صاحبه وخالقه.
شخصيات الرواية:
محجان: اسمه الحقيقي سعيد، لكنه طمس مع اشتهاره بلقبه حتى هو حين يخاطب نفسه يقول محجان متناسياً اسمه الحقيقي، غريب الأطوار كما هو لقبه، طويل القامة نحيل لكنه قوي البنية، صامت في أغلب الأحيان، عاش في أسرة فيها الأب أعمى والأم هادئة، ورث مزرعة والده، وأهتم بها بعد أن تنبه لأهميتها، تزوج ولم ينجب، الكاتب لم يذكر شيئاً عن ذلك.
عميرة: زوجة محجان وهي تمثل الشكل النمطي للزوجة في القرية العمانية التي تلازم بيتها وترعى زوجها وتهتم بكل شؤونه.
مسعودة: لها جانب صغير في الرواية، لكنه علامة فارقة في بعض اللحظات كتجسيد للشر أو لنقل لخبث العجائز.
الشيخ: وهو سيد المنطقة أو كبيرها، وما يمثله من وقار ومنزله وشيء من السيطرة، فهو يحتل الأرض الأفضل، ويعلو منزله على رابية، ولا يرغب في أن يصل أحد آخر لمنزلته.
المطوع: رجل الدين وأمام المسجد حامي حمى الشريعة في القرية وهو المتبصر في الأمور المترقب لأخطاء أهالي القرية التي تتجاوز حدود الشرع.
المحتوى:
محجان هو الذي يخلق الحدث ومعه “الروع” الذي يشكل محور الرواية فلا شيء يفوقه في الأهمية في الحكاية كلها إلا حماية الأرض التي يقف عليها، حيث أن محجان لا يريد أكثر من حماية أرضه من الحيوانات السائبة والطيور، لكن محجان صاحبنا يختلف عن البقية، فهو يحب أن يحكم عمله ويتقنه، وهذا ما قام به مع الشيء الجديد الذي كان يفكر في خلقه، ونصبه في وسط مزرعته ليحميها من كل شر، فكر في كل التفاصيل، ما يجعل الروع أقوى وما يجعله مخيف أو مرعب، ما يلبسه وكيف يشكل التفاصيل التي توحي لمن يراه أنه بشر يقف ليحمي المزرعة من كل دخيل، سواء كان ذلك الدخيل يمشي على الأرض، أو يطير في السماء.
يوطد محجان العلاقة مع الروع من أول يوم فيعامله باحترام، رغم أنه متأكد أنه من صنه ليحمي مزرعته، يلقنه ما يريد منه أن يفعل ولم يقم بذلك على نحو بسيط، بل كان حريصاً أن يكون أمام الروع في صورة السيد الذي يأمره وينتظر منه الطاعة، إلا أن العلاقة اختلفت بعد أن وجد محجان الروع يقوم بعمله على أكمل وجه، فلم يأتِ أي دخيل للمزرعة لا من الأرض ولا السماء، فزاد إيمانه بأن الروع ليس مجرد أخشاب منصوبة ترتدي أسمال بالية، بل هو كائن حقيقي يقوم بعمله وكأن به روحاً، ويزداد ذلك الشعور مع الأيام بعد أن تزدهر المزرعة، ويكثر محصولها وتتمدد.
النقطة الفاصلة في الرواية، حين وصلت علاقة محجان مع الروع لمرحلة الإيمان بأن الروع تكمن فيه روح، وأنه يستطيع الفعل، حتى أن محجان حين آذى الروع ظن أنه ينتقم منه، فعاد ليرضيه وتخلى عن إيمانه لمجرد أن يبقى مخلوقه الجبار ذو سطوة على الجميع، ثم انتقلت العلاقة إلى أبعد من ذلك حين أصبح إيمان محجان بالروع يفوق أيمانه الطبيعي، وانتقل إلى مرحلة الحب، لدرجة أنه ينتقم لأجله.
تحمل الرواية في طياتها أجواء القرية العمانية بأحاديثها ونميمتها وحسدها وترابطها، فلا حدث يمر دون أن تعرفه القرية كلها، ولا شيء يحدث حتى يشارك فيه الجميع، في الخير والشر، وتلك النفوس البسيطة التي تصدق أشياء ربما لا تكون موجودة في الواقع، لكن تلك الأشياء تحمل أساطير القرية وخيالاتها، ويتحكم في القرية المتحدثين وأصحاب النفوذ والدين.
الأسلوب:
اعتمد الكاتب أسلوب الراوي العليم، وأظنه أصاب في هذا الاختيار؛ لأنه أسلوب المتمكن من كل التفاصيل، وينقلها بشكل أوضح للقارئ دون شطط، كما إني متأكد أن أسلوب زهران القاسمي في الكتابة لا يختلف عليه اثنان، فهو يملك اللغة القوية والأسلوب الجميل المشوق، ويستطيع أن ينسج الخيال بحروفه لا في عقله ككاتب، بل في عقل القارئ.
الكاتب:
شاعر وروائي عماني ولد عام 1974، صدرت له العديد من دواوين الشعر ومجموعتين قصصية وخمس روايات أبرزها “تغريبة القافر” التي فازت بجائزة البوكر للرواية العربية.
تقييم العمل:
العمل رائع وممتع يقع في 154 صفحة من القطع المتوسط، جميل ويحمل قدر كبير من التشويق، أنصح بقراءته.



